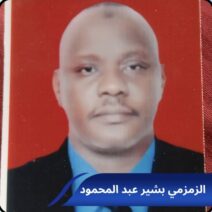📌من يصنعها؟ كيف تُدار؟ ولماذا خُلقت لتُستخدم؟
بعد أن فككنا – في الجزء الأول – المفهوم من الداخل، و أزلنا الغبار عن ثنائية العقيدة والمادة، ننتقل الآن إلى الغرف الخلفية التي صُممت فيها الدولة الوظيفية.
هذا الجزء لا يعنى بما تراه العين، بل بما يُخطط له وراء الستار:
كيف تُصنع هذه الدولة؟ من يرسم حدودها؟ من يُنتج نخبها؟ وهل لها مستقبل سوى التبخر إذا ما تغيّرت الأجندة الدولية؟
١. الهندسة الجيوسياسية: من يُصمِّم الدولة الوظيفية؟
الدولة الوظيفية لا تولد من رحم الإرادة الوطنية، بل تُصنع في غرف التخطيط الجيوسياسي:
هناك تُرسم حدودها: أين تبدأ وظائفها وأين تنتهي؟
■هناك يُحدد تمويلها: ما الحد الأعلى من السيادة الذي يسمح لها به؟
■وهناك تُنتج نخبها: من يصل إلى السلطة؟ من يُسمح له بالتحدث؟ ومن يُقصى؟
☆إنها ليست دولة بالمعنى السيادي، بل مشروعًا إداريًا لخدمة توازنات ما بعد الاستعمار.
تُدار الدولة الوظيفية كما تُدار شركة خاصة، لها مجلس أمناء (الممولين)، ومدير تنفيذي (الحاكم)، ومستشارين (السفارات)، ومستخدمين (الشعب المغلوب).
٢. غياب العدو الخارجي = ذوبان داخلي
■في الدول العقائدية، وجود العدو الخارجي يُعيد تشكيل الوعي الجمعي، ويُوحد الصفوف خلف مشروع.
■أما في الدولة الوظيفية، فالعدو الخارجي إما محظور تسميته، أو لا وجود له أصلًا، بل قد تكون وظيفتها الأساسية هي محاربة عدو الآخر.
وبالتالي:
●لا تعبئة وطنية.
●لا وعي مقاوم.
●لا بناء للمناعة السيادية.
الدولة التي لا تملك عدوًا حقيقيًا، تفتعل أعداء وهميين في الداخل لتُبرر بقاؤها وتُغطي فراغها.
٣.من يُنتج النخبة؟ النخب الوظيفية نموذجًا
■في الدولة الوظيفية، النخبة لا تُنتج من تفاعل الشعب، بل من رضا المركز المموّل.
إنها نخبة يتم تصنيعها، ثم إعادة تصديرها كواجهة تمثيلية:
●تُربّى في منصات المنح والمنظمات.
●تُدرَّب على لغة “المشاريع”، لا لغة “الرسائل”.
●تتقن خطاب “المرونة”، لا خطاب “الموقف”.
●تعرف كيف تُوقّع على نموذج دعم، لكنها لا تجرؤ على صياغة دستور.
●هؤلاء ليسوا قادة… إنهم موظفون برتبة وزراء، يُوقّعون على أجندة أُعدّت لهم سلفًا.
٤.أثر الدولة الوظيفية على السيادة القانونية
■في القانون الدولي، تكتسب الدولة شرعيتها من كونها كيانًا مستقلًا، يملك:
●إرادة حرة.
●مؤسسات ذات سيادة.
●قرار خارجي مستقل.
■لكن الدولة الوظيفية:
●لا تُموِّل نفسها.
●لا تسيطر على حدودها.
●لا تملك قرار الحرب أو السلام.
وبالتالي:
●هي موجودة في القانون، لكنها غائبة في الواقع.
●تمارس السلطة، لكنها لا تحكم.
●تحمل الاسم، وتفقد الجوهر.
هل يجوز تسمية كيان بلا قرار وبلا سيادة “دولة”؟
أم نحن أمام “حالة شبحية” تم اختراعها لشرعنة التبعية و إعادة تدوير الاستعمار بصيغة (مُمأسسة)؟
٥.هل يمكن “تعقيد” الدولة الوظيفية؟ هل تتحمل العقيدة؟
يحلم البعض بأن يُدخل العقيدة في الدولة الوظيفية، لتحويلها من الداخل.
لكن المشكلة أن بنية الدولة الوظيفية نفسها:
●لا تتحمل العقيدة.
●لا تُنتج الرموز.
●لا تسمح بالرؤية الجمعية.
كل مشروع وطني حقيقي داخل الدولة الوظيفية يُجهض إما بالاحتواء أو بالإقصاء.
فإما أن تبقى الدولة على وظيفتها، أو تنهار حين يُزرع فيها المعنى.
٥. ما بعد الدولة الوظيفية: الانقراض أم التحول؟
الدولة الوظيفية لا مستقبل لها خارج وظيفتها، وإذا انتهت وظيفتها، فإن مصيرها يكون أحد الآتي:
●الانقراض الإداري: حل الدولة أو فشلها كما حدث في ليبيا أو الصومال.
● التحول إلى منطقة نفوذ: كما في بعض مناطق الساحل الإفريقي.
●الاستبدال بشركة أو بعثة أممية: نموذج العراق تحت الاحتلال، أو كوسوفو.
إن الدولة التي لا تملك وظيفة جديدة، تُسحب منها شرعية البقاء.
٦. العقيدة والمادة في صناعة الحرب والسلم
■الدولة العقائدية: تخوض الحرب من أجل الهوية والمبدأ، وتُفاوض من موقع القوة.
■الدولة الوظيفية: تُؤجَّر للحرب، وتُستخدم كأداة في صراع ليس لها فيه مصلحة.
ولذلك، فإن الدول الوظيفية:
●تُقاتل نيابة عن الآخرين.
●وتُعاقب شعبها إذا قرر أن يُفكر بمعناه الخاص.
في الطريق إلى السودان…
الآن وقد كشفنا هندسة الدولة الوظيفية، وبيّنا كيف تُدار، وأين تبدأ وتنتهي، ننتقل في الجزء الثالث إلى حالة السودان.
سنفتح الجرح دون تخدير، ونطرح الأسئلة الحقيقية:
♤هل نحن في كيان سيادي فعلي؟
♤من يُموّل من؟ ومن يُسلّح من؟
♤ولماذا كلما حاول مشروع وطني أن يولد، تكالبت عليه الماكينة الوظيفية؟
إلى الجزء الثالث…